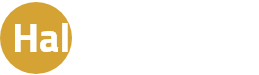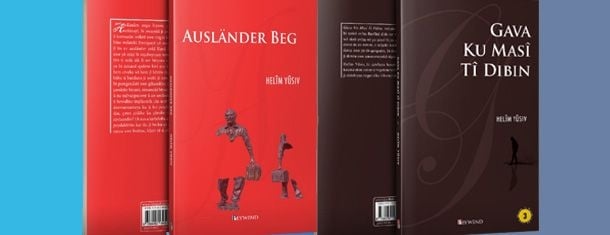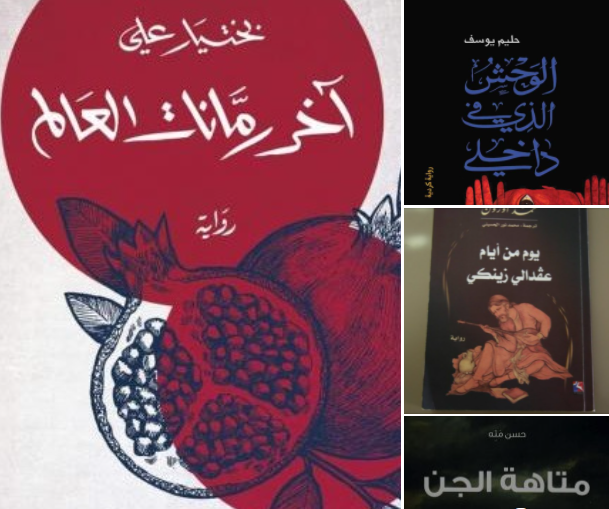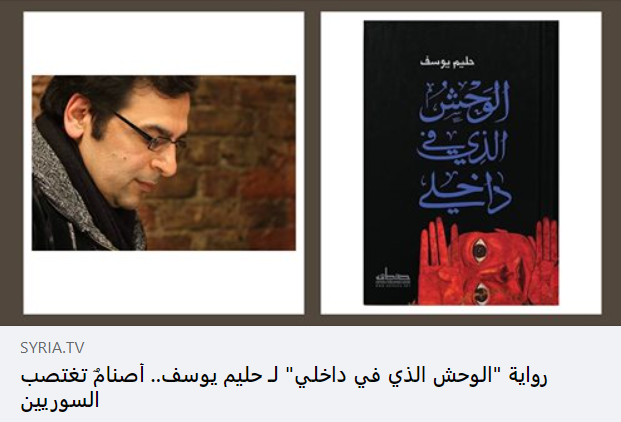Author: halimyoussef
صدور طبعات جديدة بالكردية من رواية “حين تعطش الأسماك” ومن قصص “آوسلاندر بيك”
عن دار بيوند للنشر والتوزيع صدرت في استانبول الطبعة الكردية الخامسة من رواية “حين تعطش الأسماك”، التي صدرت في طبعتها العربية عن دار مسعى للنشر والتوزيع قبل عام.كما صدرت الطبعة الثانية لقصص “آوسلاندر بيك” عن نفس الدار، علما أن الترجمة العربية للقصص قيد الانجاز.
نيسان 2021
أبرز الروايات في الأدب الكردي
جوان تتر
غُيَّبت الروايات في الأدب الكردي في مختلف اللغات، وخاصةً منها العربيَّة على مدار عقودٍ طويلة، لا يمكن إرجاعَ الأسباب سوى إلى تلك السياسيَّة التي لعبت الدور الأبرز في ذلك التغييب، أو لعلّها الأقدارُ هي من ساهمت في ذلك!.
يعود تاريخ أول كتابة لرواية كرديَّة إلى العام 1935 لتتالى بعد ذلك أشكال الرواية وتتطوَّر وفقاً لتطوِّر الخيال واللغة الكرديَّيَن، وكأي لغةٍ تُكتَب بها الرواية، اختلفت المواضيع واشتبكت الأحداث فيها، منها من تكلَّم عن تغريبة الكرديّ وسردها، ومنهم من انساق وراء همِّه الذاتي، لتتعدّد بذلك الأشكال الكتابيَّة للرواية الكرديَّة، سنتعرّف في هذا المقال المختصَر إلى أبرز الروايات الكردية وأكثرها تأثيراً.
آخر رمّانات العالم
حظيَ الروائي الكرديّ بختيار علي من مواليد السليمانيَّة- العراق 1960 بشهرةٍ أوروبيَّة قبل العربيَّة، وقُرِأ في لغة الضَّاد بعد صدور الترجمة العربيَّة لروايته المعنوَنة بـ: “آخر رمّانات العالم”، الصادرة عن دار مسكلياني – تونس وبتوقيع من المترجمين: “عبد الله شيخو و ابراهيم خليل” في العام 2019، علماً أنَّ ترجمةً أخرى للرواية صدرت خلال العام 2002 بتوقيع من المترجم الإيراني: “غسان حمدان”، إنَّما بعنوانٍ مختلف قليلاً: “آخر رمان الدنيا”. تدور أحداث الرواية التي هي من أهم الروايات في الأدب الكردي حول الأسى الكرديّ، لتصل وفق النقَّاد إلى مصافّ الرواية السحريَّة، حيثُ أحداثٌ متلاطمة، وشخصيَّات تعيشُ داخل سردٍ معذَّب، بحثاً عن خلاصها، سياسيَّاً واجتماعيَّاً ودوليَّاً، رحلةُ الكرديّ في مآسيه، الأمر الذي دفع بالناقد الألماني الشهير شتيفان فايدنر إلى التعليق على النسخة الألمانيَّة من الرواية بالقول: “قنبلة بكل معنى الكلمة”. رواية القنابل المحرَّمة دوليَّاً والأسلحة الكيميائيَّة التي استُخدِمَت ضدّ الكرد في العراق، رحلةُ البحثِ عن الولد التائه، في قالبٍ سرديٍّ أخَّاذ، روايةٌ تعكُسُ شخصيَّة الروائيّ نفسه، لتودي بالقارئ نحو الموتِ وعذاباته، ذلك الموت الذي يتحوَّل إلى موتٍ يوميّ بالنسبة إلى الإنسان الكرديّ.
الوحشُ الذي في داخلي
يعتبر الروائي الكردي السوري حليم يوسف مواليد عامودا 1967 من أبرز الروائيين المحدثين الكرد حتَّى الآن، وصدرت له عشرات الكتب بين روايةٍ وقصصَ قصيرة باللغتين الكرديَّة والعربيَّة، ولعلّ أهمّ رواياته كانت رواية: “سوبارتو”، التي حُظيت بشهرةٍ عربيَّةٍ وكرديَّة على حدٍّ سَواء، سوى أنّ روايته الصادرة في نسختها العربيَّة عن دار صفصافة في مصر والمعنوَنة بـ: “الوحش الذي في داخلي” تكادُ تكونُ الأكثر شهرةً في الوقت الرّاهن، وذلك لما فيها من تقنيَّاتٍ سرديَّةٍ تجانب الإنسان الكرديّ السوري، وأيضاً لما فيها من أحداثٍ واقعيَّةٍ لها أثرها اللامع في الذاكرة الكرديَّة السوريَّة، ولا سيَّما أنّ سوريا تعيش الآن حرباً طاحنةً، وسط قتل وتهجير الكُرد.
تدور الرواية حول مسقط رأسه، مدينته عامودا، الواقعة في الشمال السوريّ، وما عاشته المدينةُ من رعبٍ من الأب القائد الأخير الذي غيَّب تلك المدينة، وامتدّ تغييبه إلى المدن الأخرى في شمال سوريا، روايةٌ توثِّقُ سنواتٍ طويلة من مُعاشرةِ الوحوش التي تطلُّ برأسها حالَ توفّر الفرصة، لتعيث خراباً في البلد، وتتفنَّنَ في القتل. تكادُ تكونُ الأحداثُ شريطاً سينمائيَّاً مصوَّراً بتقنيةٍ سرديَّةً مفرِطَةٍ في الألم والعذاب اليوميّ، الشخصيَّات التي يتعرَّف إليها القارئُ في هذا العمل لن ينساها.
يوم من أيَّام عفدالي زينكى
تكادُ تكون هذه الرواية هي الأقرب إلى القارئ الكردي من بين الروايات في الأدب الكردي لكاتبها الروائي الكردي والمحدث الأبرز محمد أوزون 1953-2007، والحاصل على جوائز عدَّة في مجال الكتابة الروائيَّة. صدرت الرواية في ترجمتها العربيَّة خلال العام 2010 وبترجمة موقَّعة من المترجم والشاعر الكردي محمد نور الحسيني.
روايةٌ تتكلّم عن مغنٍ كردي معروف، وهو: “عفدالى زينكى”، الشخصيَّة الأسطوريَّة التي مَرِنت الغناء في يومٍ واحد، والرواية تكاد بالكامل تدور خلال يومٍ واحد، وهو تأريخٌ وإعادة إحياء لشخصية غنائيَّة، برعت في الغناء الشفاهي الكردي القديم، بالإضافة إلى مواضيع متعلّقة بالإبادة الأرمنيَّة التي حصلت على يد العثمانيين.تختلط التراجيديا الإنسانيَة والملاحم الكرديَّة والشخصيَّات الأسطوريَّة في هذا العمل الروائي لنكون أمام نتاجٍ يُعتبَر أوَّل من طرق باب الأساطير وتفعيلها ضمن الرواية والسرد.
متاهة الجنّ
من أكثر الروائيين الكرد غرابةً وبعداً عن النمطيَّة في جُلِّ أعماله الروائيَّة والقَصَصيَّة، حسن متّه، المولود في قرية ارخانيه – آمد في تركيا عام 1957، برع في كتابة الروايات القصيرة واشتهر بعوالمه السحريَّة في كامل منتوجه الروائيّ، وهذا ما سيفعله في روايته المعنوَنة بـ: متاهة الجنّ الصادرة خلال العام 2013 بتوقيعٍ من المترجم جان دوست. تتحدَّث متاهة الجنّ عن معلِّمٍ شابّ قادم من المدينة إلى القرية، حالماً بتغيير وجه العالم، سوى أنَّه سيصطدمُ بحكايات الجنّ والعفاريت، حيث مجريات الصراع القائم بين عوالم ثلاث: شاب يتحمَّس لتغيير العالم وزوجة المعلم البدوية التي تركت أهلها راحلةً مع زوجها وقرويّون بسطاء غارقون في متاهات الجنّ وحكاياتهم. اعتُبر متّه من أبرز الروائيين الكرد المعتمدين على الجملة القصيرة في سرده الروائي، ومتانة حبكته القَصصيَّة وغرابة حكاياته وانزياحها المستمرّ نحو اللا معقول، وهذا ما تنطوي عليه الترجمة العربيَّة لنتاجه الأدبيّ كذلك. الخروف الأخضر اعتُبرت رواية “الخروف الأخضر” التي صدرت خلال العام 2008 لكاتبها الدكتور آزاد أحمد علي من أولى الروايات المكتوبة باللغة الكرديَّة في سوريا، وتتأتَّى خصوصيَّة هذا العمل من ابتعاد الأحداث عن الأدلجة ومحاولة العمل بجديَّة أن يكون تأسيساً فعليَّاً للرواية الكرديَّة في سوريا.
حلقة عن الكاتب والروائي حليم يوسف
حلقة جديدة من برنامج قناديل على قناة وفضائية
Rojav TV عن ( الكاتب والروائي حليم يوسف )
إعداد وتقديم : مروان شيخي
10.01.2021
يوم مشمس في شتوتغارت: حوار بالكردية حول الكتابة والسلطة
حوار بالكردية حول الكتابة والسلطة والرواية والهجرة والقصة القصيرة والمخابرات والغربة والنيران التي التهمت أطفال سينما عاموده والتهمت معها روح تائقة الى الانعتاق من القفص الى أوكسجين الحياة.
أجرى الحوار الكاتب الكردي ابراهيم سيدو لفضائية
حليم يوسف: جناحا الأدب الكوردي مكسوران وبدون دولة لن يتبوأ أدبنا مكانته الحقيقية
يروي القاص والروائي حليم يوسف شذرات من مسيرته الشخصية والأدبية، بعد نحو 20 عاما من وجوده في بلاد المهجر واصدار العديد من المؤلفات الادبية.
بيل (كوردستان 24)- يروي القاص والروائي حليم يوسف شذرات من مسيرته الشخصية والأدبية، بعد نحو 20 عاما من وجوده في بلاد المهجر واصدار العديد من المؤلفات الادبية.
وفي لقاء خاص مع كوردستان 24 ينتقل حليم يوسف الى الماضي ليروي لنا كيف قرر الهجرة من سوريا.
ويقول يوسف “كان قراري بالهجرة مفاجئا في بدايات عام 2000 حيث شعرت بأنني أختنق في تلك البلاد مع انعدام الحرية في التعبير ومع ضغط الأجهزة الامنية المتزايد ولم يبق امامي خيار فإما أن اترك القلم والكتابة واخضع لنصيحة والدي الذي طلب مني ان اهجر الكتابة واعمل في الأرض أو اهجر غرب كوردستان وسوريا لاستنشاق بعض الأوكسجين الذي افتقدته هناك”.
ويتابع ان “عامودة موجودة في كافة نتاجاتي الادبية رغم اني بعيد عنها منذ 20 عاما، كما ان الخوف والرعب الذي كانت السلطات الامنية في سوريا حاضر دوما في رواياتي وقصصي.
انه الخوف الذي تسلل الى عظامنا هناك، ومن واجبي ككاتب أن اسلط الضوء على ذلك الجانب المظلم في الروح، ان تلك البلاد (سوريا) سقطت من شاحنة وعضتها الجغرافيا من أذنها”.
ويعزو حليم يوسف صدور رائحة الحرائق من كتاباته الى طفولته التي كانت مليئة بالأحاديث والذكريات الاليمة عن حادثة حريق سينما عامودة والتي ولد حليم بعد 7 سنوات من تلك الماساة.
ويشير حليم يوسف الى ان طفولته ورغم انها كانت مليئة بالصعوبات والمآسي لكنها في الوقت نفسه تعد خزينة ونبعا مهما للكتابة الادبية.
ويؤكد حليم يوسف ان الادب الكوردي يحاول الطيران لكن اجنحته متكسرة مشيرا الى انه لن يتبوأ المكانة التي يستحقها عالميا إلا بوجود دولة كوردية.
وحليم يوسف روائي وقاص كوردي من مواليد مدينة عامودة بشمال شرق سوريا، درس الحقوق بجامعة حلب ومقيم منذ سنوات في المانيا.
حاز يوسف على جائزة الرواية الكوردية لعام 2015 وهو عضو في نادي القلم الألماني.
صدرت له عدة روايات ومجموعات قصصية باللغتين العربية والكوردية أهمها: سوبارتو(رواية)، خوف بلا اسنان (رواية)، نساء الطوابق العليا(قصص)، الرجل الحامل (قصص)، موتى لاينامون (قصص)، وتسعون خرزة مبعثرة (رواية) وغيرها.
صدرت أعماله باللغات الكوردية، العربية، التركية، الفارسية، الانكليزية والألمانية.
سوار احمد
Kurdistan24
الرواية الكردية بين الاقصاء السياسي والابداع السردي
حليم يوسف
اذا تمعنا في بدايات الرواية الكردية نجد أن الروائيين الأوائل الذين ولدت على أيديهم هذه الرواية جاؤوا من الوسط السياسي، وبعد انخراط في العمل الحزبي على أعلى المستويات. ويشمل هذا الأمر كل من ساهم في نشوء وتطور هذا الجنس الأدبي خلال مرحلة تمتد الى نصف قرن ابتداء من رواية الراعي الكردي كأول رواية كردية ظهرت في بداية حقبة الثلاثينات من القرن المنصرم وحتى نهاية حقبة السبعينات منه. وسأشير الى أبرز ثلاثة أسماء تتوزع جغرافيا بين ثلاث مختلفة من الدول التي تتقاسم الوطن الكردي، وهم: – الأول هو عرب شمو صاحب رواية الراعي الكردي الذي كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في أرمينيا وتعود أصوله الى شمالي كردستان (تركيا). والثاني هو رحيم قازي صاحب رواية بيشمركه وقد كان عضوا في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني في ايران. والثالث هو إبراهيم أحمد صاحب رواية مخاض الشعب وقد كان عضوا في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق. وتعتبر هذه الأسماء الثلاثة مع رواياتهم الأخرى من أبرز الأسماء الروائية التي ساهمت في تشكيل اللوحة الروائية الكردية خلال ما يقارب النصف قرن. وفي هذا المنحى لم تشهد المراحل اللاحقة من تطور الرواية الكردية اختلافا كبيرا من حيث انخراط الروائي الكردي في العمل السياسي والحزبي الكردي أولا ومن ثم توجهه الى ساحات الأدب والثقافة بعد يأس مطلق من السياسة أو بعد هزائم سياسية وعسكرية غطت مراحل كاملة من التاريخ الكردي الحديث. ولذلك نجد الروائي محمد أوزون أيضا والذي برز اسمه خلال الثمانينات والتسعينات قد غادر العمل السياسي والحزبي الكردي، الا أن الارث السياسي والحزبي ظل طاغيا على مجمل مواقفه السياسية وعلى أعماله الروائية أيضا. وكان واضحا على أنه غادر العمل التنظيمي، الحزبي الا أن الهاجس السياسي بالمعنى الحزبي للكلمة لم يغادره حتى آخر يوم في حياته. الا أن تلك المرحلة كانت بمثابة الجسر الواصل بين ضفتيي السياسة والأدب، مع التحفظ الشديد من الفصل بين المصطلحين. ويمكن تسمية هذا الجيل من الروائيين الكرد على أنهم كانوا جيلا لمرحلة انتقالية بين جيل البدايات حيث السياسة هي الهاجس الأول والأخير له، وبين الأجيال الجديدة من الروائيين الكرد الذين تشكل الرواية كنص أدبي، فني، هاجسهم الأول والأخير. من الجدير بالذكر أن عنصر السياسة بحضوره الطاغي على سياقات نشوء وتطور الرواية الكردية في مختلف المراحل يعود الى الشروط السياسية والتاريخية التي رسمت ملامح التراجيديا الكردية المتواصلة كأكبرشعب من حيث التعداد، حرم من التمتع بحقوقه القومية والانسانية ولا يملك دولة قومية خاصة به حتى اليوم.
واستطاعت الرواية الكردية في العقدين الأخيرين، رغم تاريخ المنع الطويل للغة الكردية ورغم تجزئة الوطن الكردي وتقطيع أوصاله بين دول تحكمها حكومات استبدادية فاشية، من أن تنفض عن نفسها غبار الإهمال والموت ، وأن تطل برأسها من بين ركام المنع والخراب من خلال نتاجات بالغة الأهمية، تضاهي في مستواها أفضل الأعمال الروائية في العالم. ومن المفارقة أن نجد السياسة التي كانت الحامل الموضوعي لسؤال الرواية الكردية عبر التاريخ تتحول الى عامل اقصاء لها، وتساهم في تهميشها واهمالها بشكل متعمد. وهنا لا يحتاج الأمر الى الاسهاب في عرض أسباب الاقصاء السياسي لهذه الرواية، بقدر ما نحتاج الى لفت الأنظار الى تحكم مافيا السياسة والمال بمفاتيح بيوت الثقافة والابداع وخضوع العمل الأدبي الى معايير أخرى لا علاقة لها بالأدب أو الفن أو النقد. ان اقصاء الرواية الكردية هو الوجه الآخر لإقصاء الشعب الكردي من التاريخ ولإبقائه تابعا وقابلا للذوبان في اللغات والقوميات السائدة. وكما أنتجت السياسة وبنجاح نموذج “الكردي الجيد”، فقد أنتجت ساحات الفن والأدب ومنها الرواية نموذج “الروائي الجيد” و “الشاعر الجيد” و”الفنان الجيد”، وهي كلها تنويعات على كلمة “جحشك” الكردية. وقد خلقت الارتدادات الأخيرة في الفكر الجمعي الكردي ردود أفعال مختلفة لدى العاملين في الحقل الأدبي الكردي، ويمكننا التحدث عن ثلاثة أنواع من الكتاب عموما ومن الروائيين خصوصا. الأول هو خلو النصوص الأدبية من الهم السياسي تماما، واعتبار كل ما يتصل بالسياسة لوثة أيديولوجية ينبغي التخلص منها لصالح “النقاء” الفني. الثاني هو غرق النصوص الأدبية في المواضيع السياسية والشعارات وخلط الحابل بالنابل من خلال الرؤية الذاهبة الى اعتبار كل شيء سياسة. الثالث، وهو النوع الذي أميل اليه، هو خلق التوازن بين ما هو سياسي وما هو أدبي، من خلال توظيف الموضوع السياسي في النص الأدبي، وجعل السياسة خادمة للأدب وليس العكس. وهذا ما حاولت القيام به في رواية ” الوحش الذي في داخلي”
كاتب كوردي لـ”العالم الأمازيغي”:الشعب الكوردي سقط من قطار التاريخ سهوا فعضته ذئاب الجغرافيا من أذنيه
مايو 27, 2019 أخبار العالم الأمازيغي, قضايا الكرد
الكاتب الكوردي حليم يوسف“: الواقع الكردي الحالي هو امتداد لتراجيديا متواصلة يعيشها هذا الشعب السيئ الحظ الذي ابتلي وطنه بأسوأ أنواع المخلوقات، فتقاسموه واستعبدوه”
يقول الكاتب الكوردي، حليم يوسف في هذا الحوار مع “العالم الأمازيغي”، ويضيف:” شعب سقط من قطار التاريخ سهوا فعضته ذئاب الجغرافيا من أذنيه”. وحول الفيدرالية التي أعلنت من طرف الكورد بشمال سوريا، قال الكاتب الكوردي “مبدئيا من حق الكرد في أي جزء من أجزاء كردستان أن يحصلوا على حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أراضي آبائهم وأجدادهم”. وأردف :” في رأيي إنه الحل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة”.
*حاوره/ منتصر إثري*
كيف تعرف نفسك لقراء العالم الأمازيغي؟
أنا كاتب كردي من غربي كردستان – شمال سوريا. إلى جانب لغتي الأم، الكردية، أكتب بالعربية أيضا. أقيم في ألمانيا منذ العام 2000. وأقول لقراء العالم الأمازيغي من يود منكم التعرف علي عن عمق فليتفضل ويقرأ كتبي. فقد صدر لي حتى الآن عشر كتب تتوزع بين الرواية والقصة القصيرة.*
حدثنا قليلا عن الأدب الكردي باعتبارك كاتبا وروائيا أيضا؟
اذا أردنا الحديث عن الأدب الكردي فلا بد لنا من التحدث عن الأجزاء الأربعة من الوطن الكردي، كردستان، الذي يتوزع بين حدود أربع دول هي سوريا، العراق، تركيا وإيران. وكذلك التحدث عن الأدب المكتوب باللهجتين الكرديتين الأساسيتين الكرمانجية والسورانية إلى جانب اللهجات الأخرى كالزازاكية والهورامية وغيرها. وسيقودنا الحديث حتما الى التحدث عن الأبجديتين اللاتينية والآرامية. وسيتشعب الحديث بنا بالرجوع أكثر من ثلاثمائة عام عندما كتب الشاعر الكردي أحمد الخاني ملحمة الحب العظيمة مم و زين، وصولا الى تسعينيات القرن العشرين التي أعتبرها بداية نهوض الأدب الكردي الحديث الذي توزع بشكل أساسي بين الشعر والقصة والرواية. استطاعت اللغة الكردية في السنوات الثلاثين الأخيرة أن تنفض عن نفسها غبار المنع والقمع والتهميش والقتل الذي غطى شعرها طوال التاريخ، وأن تؤسس لأدب جديد لا يقل عن آداب اللغات الأخرى من حيث الجودة الفنية.*
ما هي المواضيع التي تعالجها في كتاباتك وروايتك؟
كل ما يوجد في الحياة وما لا يوجد يصلح أن يكون موضوعا للكتابة الأدبية. بالنسبة لي لا تثير في لوعة الكتابة إلا النار التي تأكل أصابعي. لا أستطيع الكتابة عن أرض لم أمش فوقها، ولا عن سماء لم أبك أو أضحك تحتها. الكتابة لدي هي حاجة روحية قبل أي شيء. حاجتي إلى الكتابة تشبه حاجة الإنسان إلى الأوكسجين للاستمرار في الحياة. كل ما أرى، يقظا أو نائما، كل ما أسمع، كل ما أشعر به، كل ما يؤرقني يمكن أن يكون موضوعا للكتابة.
* ما الذي يغذي فيك روح الإبداع الأدبي أو ما أطلق عليه «فيتامين الكتابة الأدبية» إن جاز التعبير ؟
لا أدري كيف أصابتني لوثة الكتابة، كنت طفلا صغيرا عندما وجدت نفسي محاصرا بسكاكين أسئلة وجودية، فلسفية، سياسية، تاريخية أكبر مني. أسئلة لم تكن تخلف وراءها سوى الألم. لم يكن بإمكاني، أنا الطفل الصغير وقتذاك، أن أجد جوابا مقنعا لكل تلك الألغاز المحيطة بي. ولدت في بلدة حدودية اسمها عاموده، كانت عائلة أبي “فوق الخط” وهو الخط الحديدي الذي يفصل سوريا عن تركيا، أي في تركيا وكانت عائلة أمي “تحت الخط ”أي سوريا، وأنجبتني امي بقرب ذلك الخط الحديدي الذي هو سكة قطار في الأصل، لكن لا قطار مر عليه. كان ولا زال ذلك الخط الحديدي محاطا بالألغام وبرؤوس العساكر الترك الذين يتوزعون على أبراج مراقبة يراقبون الحدود و يقتلون كل كائن حي يحاول اجتياز ذلك الخط الحديدي الملغوم. هذا عدا عن الصدمة التي خلفتها الأيام الأولى من المدرسة عندما تحدث معلم الصف معنا بلغة مغايرة عن لغة آبائنا وأمهاتنا، هي العربية التي كانت لغة موظفي الدولة والشرطة والمخابرات فقط. في تلك الأجواء كنت أبحث عن إجابات لأسئلة كانت تحزنني ولم أجد غير الكتابة ملاذا. لا أدري كيف اهتديت الى الكتابة ووجدتها تخفف الألم الشديد الذي كان يتغلغل في عظامي الصغيرة آنذاك. هكذا بدأت خربشة الكتابة لدي وتتوجت بقصص وروايات لا زالت تحمل نبضات قلب ذلك الطفل الذي كنته ولا أزال.
*سياسيا، كيف تنظرون للواقع الكردي عموماً في خضم كل المتغيرات الجارية في المنطقة؟
الواقع الكردي الحالي هو امتداد لتراجيديا متواصلة يعيشها هذا الشعب السيئ الحظ الذي ابتلي وطنه بأسوأ أنواع المخلوقات، فتقاسموه واستعبدوه. شعب سقط من قطار التاريخ سهوا فعضته ذئاب الجغرافيا من أذنيه. منعوا عنه لغته، قبروا ثقافته، نهبوا خيرات بلاده و قطعوا جسده بطريقة يصعب استئصال أجزائه المبعثرة. أحرقوا روحه وأخرجوه من جلده وكرهوه بنفسه وجعلوا منه عدو نفسه. فأصبح بذلك نصفه خائنا والنصف الآخر بقي يقاوم المعتدي، ينتفض في وجه الظلم ويقاتل في سبيل كرامته. لا زال هذا النصف المقاوم يحمل صليبه على ظهره، يبذل الدماء رخيصة في سبيل حريته، يحارب بناته قبل أبنائه للحفاظ على ما تبقى من أمل في أن ينتزع هذا الشعب الجريح حق الحياة الحرة من أفواه الموت المفتوحة على كل الجهات.
*وكيف تنظرون للتحولات الجارية والمتسارعة في سورية؟ وما تأثيرها على القضية الكوردية عامة؟
أحد الأوجه الإيجابية التي أنتجتها الكارثة السورية فيما يخص الكرد هو تحكم الكرد بقدرهم إلى حد ما وامتلاك قضيتهم بعدا عالميا يتجسد في دعم التحالف الدولي بقيادة أمريكا لهم على الصعيد العسكري وإلحاقهم الهزيمة بداعش الصغير. وما أتمناه هو أن يتوج هذا الانتصار بانتصار أكبر وهو الحاق الهزيمة بداعش أنقرة الكبير. لا شك أن الكرد معنيون مباشرة بما تطرأ من تغييرات على الساحة السورية، ولن تحل المسألة الكردية في سوريا بشكل كلي بمعزل عن إيجاد حل سياسي لكل سوريا. لذلك فان التعامل مع القضية الكردية يخضع إلى حالة المد أو الجزر حسب تغييرات ميزان القوى المحلية والإقليمية والدولية صاحبة النفوذ في الساحة السورية.
*هل يمكن الحديث عن مكاسب سياسية حققها كورد سورية بعد انخراطهم القوي في محاربة «داعش»؟
أعتقد أن موقف التحالف الدولي وأمريكا على وجه خاص يلعب دورا بالغ التأثير في هذا الأمر. يتوجب على الولايات المتحدة الأمريكية ألا تكتفي بإلحاق الهزيمة العسكرية فقط بداعش. إذا اكتفت بذلك وانسحبت تماما من اللعبة الدموية الجارية على قدم وساق في سوريا، فستدخل المنطقة برمتها في دوامة اللامتناهية من صراعات جديدة. وبذلك سيفسح المجال لداعش أنقرة أن يفلت قطعان جهادييه الأشاوس على كامل تراب الشمال السوري كما فعل قبلها بمدينة عفرين الكردية. لذلك فان المنطق يقتضي بأن تتوج أمريكا هذا الدعم العسكري لحلفائها في الساحة العسكرية على الأرض إلى دعم سياسي واضح وصريح لمناطق الإدارة الذاتية التي اتبعت نموذجا في الحكم يتوافق من حيث المبدأ مع القيم الديمقراطية الغربية الداعية إلى التعدد القومي والى الارتكاز إلى نظام المؤسسات وما إلى ذلك من مبادئ نظرية يمكن التأسيس عليها لتلقي الدعم اللازم لكي تنتقل هذه المؤسسات والهياكل الإدارية من حالتها البدائية الحالية إلى حالة فعلية تتمكن من تأمين الاحتياجات الأساسية للناس في شمال سوريا وتأمين السلام والأمان لهم ريثما تتوافق الإرادات الدولية والإقليمية على حل ينهي الكارثة السورية بشكل نهائي.
* ما تقييمكم للدور الذي لعبه الكورد في الثورة السورية؟
لا أخفي عنك تحسسي من استخدام مصطلح الثورة أو إطلاق هذا الاسم الجميل على ما حدث وما يحدث في سوريا من تناحر طائفي مقيت مغلف بحرب دموية بين نظام متوحش شوفيني مشبع بثقافة التدمير ومعارضة شوفينية، متوحشة مشبعة بثقافة الذبح. ومن المفارقات الهائلة أن تتطابق أفكار النظام والمعارضة، أفكار الذابح والمذبوح فيما يخص الكرد. إن الموقف من الكرد كشف لنا بأن المعارضة لم تنشق فكريا عن النظام وإنما تصارع النظام للظفر بالسلطة والحلول محله. من هذا الباب فان ما قاله الكرد منذ البداية بأنهم يمثلون الخط الثالث بين النظام والمعارضة لم يكن بعيدا عن الصواب. وبذلك استطاعوا أن يشكلوا لأنفسهم قوة عسكرية خاصة للدفاع عن مناطقهم هي قوات حماية الشعب وقوات حماية المرأة، وهو أكبر انجاز تاريخي للكرد السوريين في العصر الحديث
* كيف تابعتم “الخذلان” الدولي إن جاز التعبير لطموحات الشعب الكوردي في تقرير مصيره؟
من المعروف أن المصالح الاقتصادية هي التي تتحكم بمفاصل السياسة الدولية، كما أن توزع الوطن الكردي بين أربع دول وعدم قدرة الكرد على تأسيس دولة قومية، بالإضافة إلى الفشل المتتالي للثورات الكردية المتعاقبة، كل ذلك أحال دون التقاء مصالح تلك الدول الفاعلة في السياسة الدولية مع مصالح الكرد “الضعفاء” والمنقسمين على بعضهم. لذلك نجد العالم بمجمله يفضل التعامل مع الدول المغتصبة للوطن الكردي على التعاون مع الكرد أنفسهم، وهذا ما تمليه عليه مصالحه. من المحزن أن تكون السياسة على الأغلب خالية من الأخلاق ومن المبادئ الإنسانية، رغم تبجح الجميع بهذه المبادئ وبقضايا حقوق الإنسان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وما إلى ذلك من شعارات لم تعد أكثر من كونها قد أصبحت جزءا من “الفلكلور” السياسي القائم على التجميل الإعلامي لسياسات تلك الدول. وسيكون هناك دعما للكرد في حال التقاء المصالح، وهو نادر الحدوث. وأبرز مثال على ذلك ما يحدث الآن من معارك حاسمة تخوضها القوات الكردية ضد أعتى قوة متوحشة ودموية في العالم وهي داعش، وذلك بدعم أمريكي مباشر. و كما أننا وجدنا ونجد جميعا كيف أن تركيا تدخل على خط تقديم الإغراءات لأمريكا لكي تتخلى عن الكرد وتتركهم فريسة لآلتها العسكرية المدمرة. فتبيدهم فيزيائيا وتصفيهم جسديا، استكمالا للإبادة الثقافية والعرقية التي تمارسها هذه الدولة الفاشية المقيتة ضد الشعب الكردي داخل وخارج تركيا. “تركيا تُبيد الشعب الكوردي فيزيائيا وتصفيه جسديا استكمالا للإبادة الثقافية والعرقية التي تمارسها هذه الدولة الفاشية المقيتة ضد الشعب الكردي”
* وماذا عن الهجوم المستمر للنظام التركي على المناطق الكوردية؟
لم يتوقف هذا الهجوم في يوم من الأيام منذ انهيار الإمبراطورية العثمانية وقيام الدولة التركية والى يومنا هذا. قامت الدولة التركية في العام 1923 حيث انتفضت كردستان عن بكرة أبيها ضد سياسات هذه الدولة العرقية بقيادة الشيخ سعيد ببران الكردي في العام 1925 فعلق الأتراك مشنقته مع مشانق سبع وسبعين من رفاقه في آمد، ديار بكر. منذ ذلك الوقت وحتى الخامس عشر من آب في العام 1984 حين بدأ حزب العمال الكردستاني بخوض الكفاح المسلح ضد الجيش التركي، لم يهدأ الشعب الكردي يوما في التحرك من أجل نيل الحرية والاستقلال. الا أن الظروف لم تساعدهم حتى الآن لتحقيق طموحاتهم المشروعة. الدولة التركية ولأسباب تاريخية وثقافية تعاني من عقدة ال”الكردوفوبيا” فترى في الكرد خطرا وجوديا عليها، ولذلك فإنها تجند الآن آلافا مؤلفة من الجهاديين السوريين منهم وغير السوريين وتدفعهم الى المذبحة في سبيل “أمنها القومي” كما تقول. وسبق وأن صرح الكثيرون من مسؤوليهم بأن سماحهم لتعليم اللغة الكردية في المدارس سيؤدي الى انقسام وطنهم، في حين أن العكس صحيح.
*ما رأيكم في الفيدرالية التي يتحدث عنها الكورد في شمال سوريا؟
مبدئيا من حق الكرد في أي جزء من أجزاء كردستان أن يحصلوا على حق تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة على أراضي آبائهم وأجدادهم. وفي رأيي انه الحل الأمثل لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة. ونظرا لاستحالة قبول الشركاء لهم بالعيش سويا على قدم المساواة. ونظرا لصعوبة تحقيق هذا الأمر تأتي مسألة الفيدرالية في المرتبة الثانية من حيث تحقيقها للمطالب الكردية المحقة من جهة، وتجنب هذه الدول المزيد من الانقسام والحفاظ على الحدود الحالية. وهو مطلب كل دولة من هذه الدول ومطلب ملح لشعوبها ما عدا الكرد. حيث ترى هذه الشعوب في الحدود التي رسمها لهم الإنكليز والفرنسيين حدودا مقدسة وهم على استعداد أن يضحوا ويبذلوا دمائهم بالجملة للذود عن حمايتها وبقائها كما هي. قصارى القول، أن النتيجة تهمني أكثر من التسمية التي ستطلق على نظام الحكم. ما يهمني هو أن يعيش الكردي الى جانب العربي، لهما نفس الحقوق ونفس الواجبات، وأن تكون اللغتين رسميتين ويتم التعليم بهما دون تمييز. أما التسمية التي ستطلق على النظام الذي سيحقق هذا الأمر، فهو تفصيل يمكن مناقشته والوصول الى حل حوله. تعتبر الفدرالية الى جانب الإدارة الذاتية الصيغة الأكثر قبولا بالنسبة الى خصوصيات وضع الكرد السوريين.
*في شأن الكوردي ـ الكوردي، إلى أي مدى يمكن أن يشكل الحوار حلاً لإزالة الفجوة بين الكورد فيما بينهما؟
اذا تحدثنا عن الساسة الكردية بشكل عام فإننا نجد لدى الكرد ثلاثة نماذج مؤثرة تتوزع الغالبية من الشعب الكردي بين محاورها وهي الأحزاب الثلاثة الرئيسية في كردستان ، نموذج الحزب الديمقراطي الكردستاني – العراق والمجلس الوطني الكردي محسوب على هذا النموذج في بعده السوري. النموذج الثاني هو نموذج حزب العمال الكردستاني – تركيا وحزب الاتحاد الديمقراطي محسوب على هذا النموذج في بعده السوري. أما النموذج الثالث فهو نموذج الاتحاد الوطني الكردستاني – العراق، وقد تقلص نفوذ هذا النموذج في السنوات الأخيرة لصالح اتساع نفوذ النموذجين الأوليين. وتشهد الساحة الكردية منافسة على النفوذ تصل الى حد الصراع بين هذين النموذجين. ويلعب الموقع الجيوسياسي لكردستان دورا بالغ التعقيد في ادامة هذا الصراع وتعميقه. ففي إقليم كردستان العراق ما من منفذ بحري مع العالم الخارجي، وهو محكوم بالتعامل التجاري والاقتصادي مع تركيا، العدو الوجودي للشعب الكردي، وغالبا ما تبنى هذه العلاقة من قبل النموذج الأول على حساب الطعن في ظهر النموذج الثاني والوقوف الى جانب العدو التركي ضد مصالح هذا النموذج من خلال الابتزاز التركي وتهديداته بإغلاق بوابة “الحياة” الوحيدة للإقليم وإحكام قبضة الحصار والموت عليه، فيضطر الطرف الكردي إلى الخضوع لهذه الابتزاز. وقد اتبع الطرف التركي نفس المنهج لدى إجراء استفتاء الاستقلال في كردستان العراق بتهديداته المستمرة بإغلاق “الحنفية” وقطع شريان الحياة عنهم. وهذا دليل صارخ على أن الطرف التركي لا يفرق بين النموذجين فيما يخص الطموحات الكردية، لكنه يلعب على هذه التناقضات للإبقاء على حالة الفرقة والانقسام. وهذا ما يلغي أرضية الركون الى الحوار بين الطرفين الكرديين الرئيسيين، ويبقي على ديمومة الصراع الكردي الكردي. وفي رأيي لن يكون هناك حوار جاد بين النموذجين إلا إذا تحررا من ابتزاز الدول المغتصبة لكردستان وخلقت أرضية للاتفاق بينهما. ولست متفائلا بقدوم مثل هذا اليوم على المدى المنظور.
*كيف تنظرون إلى مواقف الأمازيغ من القضية الكوردية؟
لست مطلعا على تفاصيل القضية وليست لدي المعلومات الكافية لتقييم مواقف الأمازيغ من القضية الكردية. علما أنني أسمع وأقرأ بين الفينة والأخرى أخبارا عن تعاطف الأمازيغ مع القضية الكردية، لكنه تعاطف لا يرتقي الى المستوى المطلوب بأن يترجم على أرض الواقع الى مشاريع مشتركة تخدم مصالح الشعبين الكردي والأمازيغي وتساعدهما على تحقيق الطموحات القومية المشروعة التي يسعى اليها الجانبان.
*ما هي أبرز نقاط التلاقي والتشابه بين الكورد والأمازيغ ؟
أعنقد أن توزع وطنهما بين عدة دول والاضطهاد القومي الذي اتبع من قبل هذه الدول المستبدة ومنع اللغتين الكردية والأمازيغية على يد سلطات هذه الدول هي نقاط التلاقي والتشابه الأساسية بين الكرد والأمازيغ. كما أن هذا الوضع المزري هو الذي يقف وراء تشابه الشعبين بالكفاح من أجل استعادة الكرامة المهدورة ونيل الاستقلال، والتقائهما على ضفة البحث عن الحرية والانعتاق من نير ظلم الأنظمة المستبدة.
*في نظركم ما هي السبل الممكنة والناجعة لتطوير علاقة الشعبين ؟
ان العلاقة السياسية خاضعة لتقلبات المصالح وتتغير سلبا وإيجابا حسب تغير الأوضاع المستجدة، لذلك فإنها غالبا ما تكون وقتية وزائلة. في حين أن العلاقة الثقافية التي تستند على تعارف روحي عميق بين الشعبين تبقى الأكثر جدوى، ولا ترتبط مع تقلبات السياسة والمصالح المتغيرة. وسأذكر مثالا مباشرا على ذلك، لتطبع وتوزع دور النشر الأمازيغية الكبيرة خمس روايات كردية بالأمازيغية أو بالعربية حتى لتعريف القراء الأمازيغ بالشعب الكردي وبأدبه الحديث. ولتفعل دور النشر الكردية الأمر نفسه للكتاب الأمازيغ. ومن ثم يتم عقد ندوات ثقافية مشتركة هنا وهناك من قبل المؤسسات الثقافية ليتعرف كتاب الشعبين أيضا على بعضهم. قد يكون مثل هذا المشروع بداية لمشاريع أكبر يتم من خلالها تقارب الشعبين على الصعد الثقافية والفنية. وهذا ما سيؤدي إلى تعزيز التعارف وترسيخ التضامن بين القوى السياسية المؤثرة لدى الشعبين، للوصول الى علاقة ترتقي إلى مستوى الجراح المثخنة التي تكوي روح الشعبين، وتحاكي تطلعاتهما المشتركة باتجاه الظفر بالحرية والاستقلال
*مساحة حرة للتعبير عن ما تود قوله؟
شكرا لكم على جهودكم القيمة في مسعى بناء الجسور بين شعبين عريقين خانهما التاريخ وأجرمت بحقهما الجغرافيا، والشكر موصول لكل القائمين على منبركم الثقافي الذي يهتم بقضية شعبنا الكردي ومسعاه في سبيل الحصول على حقوقه الإنسانية المشروعة. وكلي أمل في أن تساهم هذه الحوارات في التعارف و التقارب بين الكرد والأمازيغ.http://www.amadalamazigh.press.ma/%D9%83%D8%A7%D8%AA…/…
في حوار مع شبكة آسو لا توجد رواية كردية تكتب بلغة غير اللغة الكردية
أجرت الحوار آريا حاجي
النص الكامل للحوار الذي أجرته معي شبكة آسو وتم نشره في موقع الشبكة بشكل مجتزأ
أبريل 2019
كيف تصف واقع الرواية الكردية اليوم؟
يمكننا التحدث عن واقع جديد للرواية الكردية تشكل مع بداية تسعينيات القرن المنصرم وحتى الآن ، وذلك بعد تحولات سياسية وثقافية هائلة شهدتها كردستان بجزأيها الجنوبي والشمالي. في جنوبي كردستان بدأ الكرد يتمتعون بنوع من الأمان بعد الحماية الأمريكية لسماء كردستان وتمتع الاقليم الكردي بنوع من الاستقلالية والحرية، فشهدت اللغة الكردية والكتابة بها مرحلة جديدة. وفي تلك الأثناء تم رفع الحظر عن اللغة الكردية ولو بشكل جزئي في شمالي كردستان وتركيا، فصدرت المجلات والكتب الكردية ونفضت الكردية عن نفسها غبار عقود من التهميش والانكار والقمع. وتلى كل ذلك ما حدث في روجآفا من تحولات تاريخية شهدتها اللغة الكردية التي بدأت تدخل المدارس وتنتقل من حيزها الشفوي الى حيز كتابي يضمن لها البقاء والاستمرار. وفي ظل هذه التحولات الهائلة التي جرفت معها اللغة الكردية من حال الى حال، شهدت الرواية الكردية نوعا من النهوض الذي تجسد في بروز جيل كامل من الروائيين الكرد الذين يقدمون نتاجات ملفتة تتأسس على محاولة جدية لانتاج أدب كردي حديث لا يقل جودة فنية عن الأدب الذي يكتب بلغات أخرى. وفي هذا الاطار يمكننا التحدث عن رواية كردية جديدة لا تقل عن الروايات التي نقرؤها في اللغات الأخرى، لكنها لا تضاهي روايات اللغات الأخرى من حيث العدد, وذلك لأسباب لا تخفى على أحد. أنا متفائل بمستقبل الرواية الكردية.
هل استطاعت الرواية الكردية الوصول إلى عمق الواقع الكردي بمعنى آخر هل هناك نتاجات من صلب الواقع في المنطقة؟
كل الروايات المكتوبة بالكردية تستقي مواضيعها من صلب الواقع الكردي وتغوص عميقة في حيثيات الجرح الكردي المفتوح على جهات أربعة. هناك من يعتبر ذلك مأخذا على الرواية الكردية ويتهمها بالدوران في فلك الهم القومي والسياسي، الا أن ذلك يعتبر نتيجة طبيعية للتراجيديا المتواصلة التي يعيشها الكردي دون غيره منذ قرون. تتنوع المواضيع في الرواية الكردية بتنوع الحياة وتعدد ألوانها، لكن الجرح الكردي الغائر في عمق التاريخ يجذب كل الروايات الكردية نحوها بشكل أو بآخر. ان الرواية الكردية مرشحة أكثر من غيرها من الأجناس الأدبية لتوثيق الألم الكردي من ناحية ولنقله خارج الجغرافيا الكردية ونشره في كل أصقاع العالم من ناحية أخرى.
كروائي كردي أي اللغات تستطيع عبرها إيصال الهدف من روايتك “اللغة الكردية أم العربية”؟
يتوجب أولا وضع النقاط على الحروف ونفض غبار الالتباس عن المصطلح. الروائي الكردي هو الروائي الذي يكتب رواياته باللغة الكردية، ولا يمكن اعتبار الروايات العربية جزءا من الأدب الكردي وان كان كتابها كردا. بالنسبة لي كتابة رواية كردية جميلة بحد ذاتها هدف. الرواية لدي ليست وسيلة للوصول الى شيء ما أو تحقيق هدف ما وانما هي غاية بحد ذاتها. بدأت النشر بالعربية في بداياتي ومنذ صدور مجموعتي القصصية الأولى “موتى لا ينامون” بالكردية في العام 1996 وحتى الآن تراجعت الكتابة بالعربية لدي وأصبحت في المرتبة الثانية بعد لغتي الأم، الكردية، الا أنني لم أتخل عن الكتابة بها حتى اليوم. وقد استقر بي الحال على ذلك وسأستمر على هذا المنوال. أي أنني عدت الى طبيعتي. من الطبيعي أن يكتب الفرنسي بالفرنسية، العربي بالعربية، الألماني بالألمانية والكردي بالكردية. وبذلك فان الكردية بالنسبة لي هي اللغة الأكثر قدرة على التغلغل في حرائق الروح والقبض على جمرة الكتابة باحكام وبكل الأصابع. لمَ ننجح كروائيين كرد في الكتابة بغير لغتنا أكثر من الكتابة بلغتنا ؟ ألا زلنا ضحايا الاستبداد ؟ أم إننا لم نعد نأبه باللغة التي حرمنا منها ؟ ما رأيك ؟في هذا السؤال مغالطات عديدة، لا توجد رواية كردية تكتب بلغة غير اللغة الكردية، لذلك فان الروائيين الذين يكتبون بغير لغتنا هم روائيوا تلك اللغة ولا علاقة لهم بالأدب الكردي. وفي المراحل السابقة وحتى ثمانينيات القرن الماضي، ونتيجة منع الكردية وتداولها واستحالة العثور على المصادر الكردية، يمكن فهم اقبال الكتاب الكرد على الكتابة بلغات الدول التي تتقاسم الوطن الكردي ومنها العربية. وقد برزت أسماء كردية كثيرة في الشعر السوري وفي القصة السورية الحديثة وفي الرواية السورية على سبيل المثال. الا أنه لا يمكن تصنيف نتاجاتهم في خانة الأدب الكردي وان انحدر أصحابها من أصول كردية. وفي رأيي لم يعد مقبولا أن يصر الكاتب الكردي اليوم على الكتابة بلغة غيره، طالما أن التطورات التكنولوجية أتاحت تعلم الكردية للجميع. ولا يعني هذا التخلي عن الكتابة باللغات الأخرى. ومن باب التوضيح أقول بأنني لست ضد الكتابة بأية لغة من لغات العالم، وكل كاتب حر في اختيار اللغة التي يكتب بها. الا أن رأيي هو أن اللغة هي التي تحدد هوية الأدب الذي ينتمي اليه هذا الكاتب أو ذاك.
إلى ماذا تحتاج الرواية الكردية لتصل لمستوى الروايات العالمية؟
علينا أن ندقق في ماهية مصطلح “الرواية العالمية” قبل أن نغرق في تحليل الأسباب والنتائج. ان العالمية خاضعة الى أمر محوري في هذا السياق وهو التسويق. ومن يقف وراء تسويق هذه “الروايات” هي دور نشر كبيرة لها رأسمال ضخم، بالاضافة الى بعض الجوائز العالمية كنوبل للآداب وغيرها. ولو تبنت دار نشر غربية ضخمة تسويق احدى الروايات الكردية لوصلت الرواية الكردية الى العالمية بين ليلة وضحاها. والمربك في المسألة أن المعايير التي تتحكم بتبني دور النشر هذه لهذه الرواية أو تلك على الأغلب ليست فنية، وانما تخضع لقضية التسويق. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فان عدم وجود دولة كردية أو كيان سياسي كردي يعني عدم وجود مؤسسات ثقافية أو مؤسسات خاصة بالترجمة وعدم توفر الدعم المادي، كل ذلك يحيلنا الى القول بأن الطريق أمام الرواية الكردية مليئة بالمصاعب والعوائق. وكل ما تبقى للروائيين الكرد هي الجهود الفردية التي يبذلونها لترجمة رواياتهم الى لغات أخرى. هي جهود جبارة، لكنها تظل محدودة التأثير والاتساع في ظل انعدام الدعم المؤسساتي لها. حتى الآن
لماذا ترتكز الثقافة الكردية على الشعر و القصة أكثر من الرواية؟
بقيت الثقافة الكردية طوال التاريخ شفوية ولم تتح لها فرصة الكتابة الا مؤخرا. وفي تاريخ الأدب الكردي المكتوب نعثر على فجوات تاريخية تجعلنا نستغرب من بقاء هذه اللغة حية حتى الآن أمام قتلها المتواصل على يد الترك والعرب والفرس وهدر دم من يكتب بها. الشفوية هي السمة الأبرز لهذه الثقافة. وأكثر الأجناس الأدبية قابلة للتداول الشفوي من جيل الى آخر هو الشعر، وتأتي الحكاية الشعبية التي تناقلها القوال والمغني الشعبي في المرتبة الثانية، حيث تناقلت الأجيال عشرات الملاحم والقصص والحكايات الشعبية التي دونت فيما بعد على أيادي الباحثين. وجمع بعض الكتاب الكرد تلك القصص في كتب خاصة وجدت طريقها الى النشر في السنوات الأخيرة. وأعداد هذه الكتب التي تتضمن الحكايات الشعبية أكبر بكثير من أعداد المجموعات القصصية التي تتضمن القصة الحديثة. وان كان التراث الكردي بشكل خاص والشرقي بشكل عام يحتوي على الكثير من القصص والروايات والحكايات التقليدية الا أن الرواية بمفهومها الحديث المتعارف عليه اليوم هي ابنة شرعية للثقافة الغربية، وقد انتقلت الى الثقافة الشرقية بعد مرور عقود على ولادتها . لذلك فان بدايات الرواية العربية مثلا تعود الى بدايات القرن العشرين، وكذلك الرواية الكردية فقد ولدت في بداية الثلاثينات من القرن المنصرم.
هل تقوم الجهات المعنية و الاتحادات الثقافية بكامل واجباتها تجاه تطوير الرواية الكردية و تقديم ما يلزم لها؟
لا توجد جهات معنية بالرواية الكردية، وما من مؤسسات سياسية أو ثقافية كردية تدعمها على الاطلاق. كما أن الاتحادات الثقافية لا حول لها ولا قوة بهذا الخصوص. ما من جهة وما من أحد وما من طرف يمكن التعويل عليه لتطوير الرواية الكردية سوى الروائيين الكرد أنفسهم. الأمر يتوقف عليهم، على جهودهم الشخصية، على طاقاتهم الإبداعية وعلى تفانيهم في العمل على الاستفادة من التقنيات الهائلة التي تم اعتمادها عبر التاريخ الطويل للرواية وتسخيرها في خدمة الرواية الكردية، لكتابة رواية جميلة، شكلا ومضمونا، لا تقل شأنا عن الرواية التي تكتب في اللغات الأخرى على امتداد العالم.
واقع دور النشر و الطباعة في المنطقة و مدى تأثيرها على تطور الواقع الثقافي ككل. كيف يؤثر الدعم المادي وغياب حقوق الطبع والنشر على الحالة الإبداعية لك كروائي وللروائيين الكرد بشكل عام ؟
أكثر من ربع قرن مر على صدور أول كتاب لي، منذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم أتلق أي دعم مادي أو غيره من أية جهة كانت لطباعة كتبي وأعمالي، سوى من والدي رحمه الله، الذي طبع كتابي الأول على حسابه وندم فيما بعد على خسارته المادية مقابل نشر القصص “الفاضحة” التي نشرتها في كتابي الذي أنزل علي غضب من كتبت عنهم في بلدتي الحبيبة، عاموده. وقد شعر أبي الذي لم يكن يعرف العربية في حياته كلها بأنه خدع من قبلي، بعد أن سمع فيما بعد من الآخرين وبعد حدوث خناقات ومشادات حول بعض القصص، بأنها قصص “فضائحية” على حد قوله. بالنسبة لي، لا توجد أية مشكلة أو صعوبة في طباعة ونشر رواياتي بالكردية، حيث تصدر كل كتبي الجديدة منها والقديمة منها بطبعاتها الجديدة عن دار بيوند في استانبول وآمد، وفق الشروط المتبعة من ناحية حماية حقوق المؤلف وما الى ذلك من قواعد متعارف عليها بخصوص الطباعة والنشر. أما عن الدعم المادي، فقد فهمت موضوع انشغالي في مجال الكتابة الكردية مبكرا. عرفت منذ البداية بأنني لا أستطيع العيش من خلال الكتابة الكردية، لذلك قررت أن أبحث عن عمل أعيش منه وأدير من خلاله أموري المعيشية والحياتية، وأن أتابع عملي في مجال الكتابة الكردية جنبا الى جنب مع هذا العمل. وهذا ما أفعله الآن. انه أمر بالغ الصعوبة، لكن لا خيار أمامنا سوى ما ذكرت.
إن سمحنا لأنفسنا أن ندخل لأغوارك قليلاً ، فما المشاعر المكتومة التي سنجدها في أعماقك ولم تلق فرصة كي تخطها على الورق أو على شاشة اللابتوب ؟ خصوصاً في آخر ٨ سنوات ؟
عندما أكتب أترك شرطي المجتمع والسياسة أمام الباب، وأقوم برحلة الغوص اللذيذ في الأعماق، في الأخيلة، وفي سبر الأغوار بكل حرية. أطلق العنان لمشاعري ولأحاسيسي ولخلجات روحي أن تتدفق كما تشاء لها سخونة اللحظة التي أعيشها وقت الكتابة. وأترك مساحة صغيرة للعقل بأن يتحرك فيها لينسج خيوط اللعبة الفنية التي تساهم في بناء النص الأدبي الذي أعمل عليه. هذا بشكل عام، لذلك لمن يود معرفتي يمكنه العودة الى كتبي، روحي تتسرب بين حروف كل كلمة أكتبها، ولم أمنع نفسي يوما، تحت أي ظرف كان، من قول ما يجب أن يقال. لذلك لا توجد في أعماقي مشاعر مكتومة لم تتسرب الى كتبي بعد. أما ما يتعلق بأحداث السنوات الأخيرة في روجآفا وفي عموم سوريا فقد عشت تفاصيلها اليومية، رغم بعدي الجغرافي، عن المكان. روايتي الصادرة حديثا ” الوحش الذي في داخلي” تتناول البحث عن الذي أيقظ الوحش الذي كان نائما في داخل كل منا، نحن أبناء وبنات هذا المكان المنكوب. وروايتي القادمة التي انتهيت من كتابتها للتو تتناول أيضا وجها آخر من وجوه هذا المكان في بحثه الفاجع عن سراب يتموج على شكل حرية. لقد قلت حتى الآن كل ما كنت مقتنعا به، قلت كل ما كان يجب أن يقال.
رواية “الوحش الذي في داخلي” لـ حليم يوسف.. أصنامٌ تغتصب السوريين
تاريخ النشر: 26.03.2021 | 10:54 دمشق
ضاهر عيطة
يفكك الكاتب السوري الكردي “حليم يوسف” صور الحياة السورية الاعتيادية، ليصل إلى ما هو خفي منها، وهو وإن كان يؤسس للمتخيل، ولجعله موضوعاً لروايته “الوحش الذي في داخلي” إنما يوظفه، كمعادل موضوعي للواقع السوري، الذي حكم لعقود من قبل آل الأسد، أو”عائلة الوحش” جاعلًا من تمثال حافظ الأسد، تيمة أساسية في روايته، لا بوصفه مجرد كتلة حجرية، إنما كائن ينتمي إلى فصيلة الوحوش، وقد حل بغتة على حياة السوريين، ليغتصب المكان، ويخنق حركة الزمان، وتتسللت سموم أنفاسه إلى أرواحهم، فيتحول من يقطن في هذا الفضاء السوري، نسخة عن هذا الكائن الحيواني، وتماثيله تتناسخ عنها آلاف التماثيل، لتجثم على الصدور، كلعنة، فمعظم المهن والفنون، باتت تقتصر على صناعة ونحت التماثيل، ولأجلها تستهلك الأعمار، كحال النحات الأرمني “آرام” الذي ينحت تلك التماثيل في العلن، ويمارس البكاء في الخفاء، حتى صار للتماثيل قدرة التحكم في حياة الناس.”سالار” بطل الرواية، يخرج من رحم أمه عند قاعدة التمثال، ورغم أن المخاض كاد يميت الأم “سوسن” وقد استعصى على الداية التعامل معه، فتنصح”الحاج محمود” بنقل زوجته إلى المشفى فورًا، وتحت جنح الظلام، بواسطة عربة يجرها حصان “سوسن” لا تكف عن صراخاتها المرعبة طوال الطريق، حتى تمنى “الحاج محمود” لو أن أصوات أذان الفجر المنبعث من المسجد لا تنقطع، عساها تطغى على صراخ زوجته، غير أن صوت أذان الفجر توقف، وصراخ الأم استمر يشق عنان الصمت، ولكن ما إن تصل بهم العربة عند قاعدة تمثال الرئيس، تحدث المعجزة، ويخرج الجنين “سالار” فجأة من رحم أمه، وهو في طبيعة تكوينه الجسدي أقرب ما يكون إلى حيوان، إذ سرعان ما نبت له ريش وأجنحة، وراح يطير بعيدًا، ليسبق الأم والأب إلى البيت، ونظرات التمثال تبتسم للأم الغارقة بدمها وهي عند قاعدته. هو حلم كابوسي، راود الأم”سوسن” حين ولدت طفلها “سالار” وكلما مرت قرب التمثال و”سالار” برفقتها، تتذكر ذلك الكابوس، والطفل يصر على الوقوف أمامه، طارحًا جملة من الأسئلة المحرمة على والدته: “لماذا يبقى التمثال رافعًا يديه طوال الوقت؟ ألا يتعب؟ ألا يتبول مثل الناس جميعًا؟ ألا يآكل؟ ألا يموت..؟”.والأم تتحسس اقتراب اللعنة التي ستحل عليهم جراء تلك الأسئلة القاتلة، وعن هذا التمثال، تتناسخ عنه عدة سلالات من الوحوش، ليتم ترويضها، فتتحول بدورها إلى وحوش مشابهة، حتى أن الطفل “سالار” لا ينجو من التحول، الذي بدأت ملامحه تتبلور، منذ اليوم الأول لدخوله المدرسة، حيث تستأصل منه عفوية الطفولة من قبل مدير المدرسة، حين دخل عليهم الصف، مباغتًا الأستاذ “آلان” الذي كان يعطي درسًا في اللغة العربية، ويقرأ سورة يوسف، بصوت رقيق عذب، وهو لا يكف عن البكاء، مما دفع “سارلا” للبكاء بدوره، رغم عدم فهمه لمضمون الآية، لكن مع دخول مدير المدرسة، وحديثه عن المظاهرة المليونية التي ستقيمها الجماهير لأجل تخليد حياة القائد، تعم أجواء الصف حالة الرعب والقهر، والطفلة “مريم” ماعادت تستمتع بشد ضفائرها من قبل الأصدقاء، وفي اليوم الثاني، في خضم المظاهرات يحاول “سالار” أن يخرج عن قطيع المتظاهرين، وينفرد للعب في زاوية وسط هتاف الجماهير بحياة الأب القائد، لكن سرعان ما يتلقى عقوبة عن لهوه هذا، فيداهم عناصر الأمن منزله، ويعتقلونه مع والده، لكونه لم يحسن تربيته، وإن كانوا قد أفرجوا عنهما بعد فترة قصيرة، فإن مصير الأستاذ “آلان” يكون أشد رعبًا وهولًا، والتهمة “عدم تربية طلابه على حب القائد” مما يكلفه سنين طويلة من عمره يقضيها في المعتقل، وابنته “مريم” صديقة “سالار” في الصف، تعيش في يتم وحزن، وحين بلغت عمر الصبا، و”سالار” واقعًا في هواها، لم يستطع الأخير أن يلتقي بها في أي مكان على أرض هذه البلاد، إلا في أرجاء المقبرة، على أجساد الموتى، وهناك راحت تنشأ قصة حب كتب لها أن تموت وهي لم تكد تولد بعد، حين يعتقل “سلار” العائد قريبًا من بيروت، بعد أن أكمل تعليمه في اللغة الفرنسية. فقط لمجرد الشك في احتمال أن يكون هو صاحب الكتاب الذي يحمل عنوان “الأب والابن” ليقضي بدوره سنوات شبابه في المعتقل، وحين يخرج منه، ويعود إلى البيت، يباغت بموت أمه، وقد صار والده عجوزًا، ووحيدًا، وحتى وإن كان أستاذه “آلان” قد خرج من السجن، فيخرج منه وقد استحال إلى هيكل عظمي، غير أن الصدمة الكبرى بالنسبة إلى “سالار” غياب “مريم” عن البيت، وزواجها. على هذا النحو تنتهي مصائر الناس، وقصص الحب، والأحلام في بلد تحكمه التماثيل الحجرية، كحال النحات “آرام” الذي استهلك عمره في نحت التماثيل، وما من خيار أمامه، طالما أن عناصر الأمن، يواظبون على التردد إلى مرسمه، وحال صاحب المكتبة لا يختلف، فالمكتبة التي كانت المكان الأعز لدى “سالار” تغدو فضاء يعج بعناصر الأمن، ونتيجة للقهر والرعب، يغدو صاحب المكتبة عنصر أمن، ويأخذ على عاتقه التحقيق مع “سالار” عما إن كان هو مؤلف كتاب “الأب والابن” ومن الطريف والعبثي، أن ثمة تقارير في الأفرع الأمنية عن مشتبه بهم، من أمثال المفكر الفرنسي “جان بول سارتر”، والرسالم الهولندي “رامبرانت” وغيرهم، وتصدر بطاقات بحث عنهم في الحواري والأزقة السورية. وكان من الطبيعي في مثل هذه الأجواء الموبؤة بالوشيات والرعب والخوف، إنتاج كائنات متوحشة، حتى إذا ما آن الأوان، سارعت إلى نهش لحم بعضها، ليكتشف “سالار” أنه تحول بدوره إلى وحش، وقد نبتت لديه ذيول، كما حال الآخرين الذين يحيطون به.ضمن هذه الأجواء الغرائبية، صاغ حليم موسى روايته، كمقاربة فنية لواقع الحياة السورية، ليدخلنا في دهاليز ومتاهات، مدللًا من خلالها على مكامن العطب في الحياة السورية، ليكنس العماء الذي استحكم بالإنسان الكردي والأرمني وغيرهما من المكونات السورية، ممن ولد وترعرع في دولة البعث، مفككًا أسرار ما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن. فحين يتم الإفراج عن “سالار” يكون قد تحول إلى وحش، في لحظة كانت فيها سلطة الأجهزة الأمنية، أحوج ما تكون لأمثاله من الوحوش، لغزو الشوارع والمدن، لاسيما وأن ضيق السجون بالمتظاهرين، لم يعد يستوعب أعداد الوحوش فيها، مع من يتم الزج بهم حديثًا لتكتمل عمليه وحشنتهم في المعتقلات، وهي وإن كانت مجرد استعارات، وترميزات، إلا أنها صورت بدقة متناهية حقيقة ما جرى في سورية، الدولة المتوحشة، وكلما ظهرت أداة تحول دون توحش الكائن الإنساني فيها، كالكتب واللعب والحب والفن؛ يتم حرقها وخنقها. حتى أن الأغاني والألحان الموسيقية التي كان يواظب عليها “خليلو” الأعمى، آتت الوحوش المتناسخة عن التمثال الحجري لتستأصلها من حياته، وكان لـ”خليلو” الأعمى، صديق “سالار”، الأثر الأكبر في مقاومة هذه الوحشية، عبر معزوفاته الموسيقية وأغانيه العذبة، إلى حد بدا فيه “خليلو”، وكأنه حارس على ما تبقى من الجمال في الحياة، غير أن تلك الحياة وأناسها، بدوا وكأنهم محكومين بلعنة الطاعون، وما من خلاص منها، طالما وأن التماثيل الحجرية جاثمة على صدورهم، وكأن نبوءة الأم “سوسن” كانت تحاكي نبوءة العراف “ترسياس” في مسرحية “أوديب ملكًا” حول مصير ابنها “سالار” الذي يمضي باحثًا عن مصدر هذا الطاعون، ما أوصله في نهاية المطاف إلى الاغتراب عن نفسه، تواقًا للعود إلى رحم الأم، أو الموت، كما هام “أوديب” في عماء عتمته، حين أدرك سبب الطاعون، واستمرت ماكينة الخياطة، بصوتها الذي يطحن عمر والدة “مريم” تعكس أثرًا كبيرًا في خلق الإيقاع الموجع الذي طغى على أجواء رواية حليم يوسف.
حوار تلفزيون النيل الثقافي في القاهرة
تم اجراء هذا الحوار على هامش المشاركة في مهرجان القاهرة الثقافي في شباط العام 2019