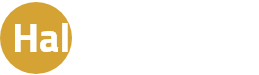رواية “الوحش الذي في داخلي” لـ حليم يوسف.. أصنامٌ تغتصب السوريين
تاريخ النشر: 26.03.2021 | 10:54 دمشق
ضاهر عيطة
يفكك الكاتب السوري الكردي “حليم يوسف” صور الحياة السورية الاعتيادية، ليصل إلى ما هو خفي منها، وهو وإن كان يؤسس للمتخيل، ولجعله موضوعاً لروايته “الوحش الذي في داخلي” إنما يوظفه، كمعادل موضوعي للواقع السوري، الذي حكم لعقود من قبل آل الأسد، أو”عائلة الوحش” جاعلًا من تمثال حافظ الأسد، تيمة أساسية في روايته، لا بوصفه مجرد كتلة حجرية، إنما كائن ينتمي إلى فصيلة الوحوش، وقد حل بغتة على حياة السوريين، ليغتصب المكان، ويخنق حركة الزمان، وتتسللت سموم أنفاسه إلى أرواحهم، فيتحول من يقطن في هذا الفضاء السوري، نسخة عن هذا الكائن الحيواني، وتماثيله تتناسخ عنها آلاف التماثيل، لتجثم على الصدور، كلعنة، فمعظم المهن والفنون، باتت تقتصر على صناعة ونحت التماثيل، ولأجلها تستهلك الأعمار، كحال النحات الأرمني “آرام” الذي ينحت تلك التماثيل في العلن، ويمارس البكاء في الخفاء، حتى صار للتماثيل قدرة التحكم في حياة الناس.”سالار” بطل الرواية، يخرج من رحم أمه عند قاعدة التمثال، ورغم أن المخاض كاد يميت الأم “سوسن” وقد استعصى على الداية التعامل معه، فتنصح”الحاج محمود” بنقل زوجته إلى المشفى فورًا، وتحت جنح الظلام، بواسطة عربة يجرها حصان “سوسن” لا تكف عن صراخاتها المرعبة طوال الطريق، حتى تمنى “الحاج محمود” لو أن أصوات أذان الفجر المنبعث من المسجد لا تنقطع، عساها تطغى على صراخ زوجته، غير أن صوت أذان الفجر توقف، وصراخ الأم استمر يشق عنان الصمت، ولكن ما إن تصل بهم العربة عند قاعدة تمثال الرئيس، تحدث المعجزة، ويخرج الجنين “سالار” فجأة من رحم أمه، وهو في طبيعة تكوينه الجسدي أقرب ما يكون إلى حيوان، إذ سرعان ما نبت له ريش وأجنحة، وراح يطير بعيدًا، ليسبق الأم والأب إلى البيت، ونظرات التمثال تبتسم للأم الغارقة بدمها وهي عند قاعدته. هو حلم كابوسي، راود الأم”سوسن” حين ولدت طفلها “سالار” وكلما مرت قرب التمثال و”سالار” برفقتها، تتذكر ذلك الكابوس، والطفل يصر على الوقوف أمامه، طارحًا جملة من الأسئلة المحرمة على والدته: “لماذا يبقى التمثال رافعًا يديه طوال الوقت؟ ألا يتعب؟ ألا يتبول مثل الناس جميعًا؟ ألا يآكل؟ ألا يموت..؟”.والأم تتحسس اقتراب اللعنة التي ستحل عليهم جراء تلك الأسئلة القاتلة، وعن هذا التمثال، تتناسخ عنه عدة سلالات من الوحوش، ليتم ترويضها، فتتحول بدورها إلى وحوش مشابهة، حتى أن الطفل “سالار” لا ينجو من التحول، الذي بدأت ملامحه تتبلور، منذ اليوم الأول لدخوله المدرسة، حيث تستأصل منه عفوية الطفولة من قبل مدير المدرسة، حين دخل عليهم الصف، مباغتًا الأستاذ “آلان” الذي كان يعطي درسًا في اللغة العربية، ويقرأ سورة يوسف، بصوت رقيق عذب، وهو لا يكف عن البكاء، مما دفع “سارلا” للبكاء بدوره، رغم عدم فهمه لمضمون الآية، لكن مع دخول مدير المدرسة، وحديثه عن المظاهرة المليونية التي ستقيمها الجماهير لأجل تخليد حياة القائد، تعم أجواء الصف حالة الرعب والقهر، والطفلة “مريم” ماعادت تستمتع بشد ضفائرها من قبل الأصدقاء، وفي اليوم الثاني، في خضم المظاهرات يحاول “سالار” أن يخرج عن قطيع المتظاهرين، وينفرد للعب في زاوية وسط هتاف الجماهير بحياة الأب القائد، لكن سرعان ما يتلقى عقوبة عن لهوه هذا، فيداهم عناصر الأمن منزله، ويعتقلونه مع والده، لكونه لم يحسن تربيته، وإن كانوا قد أفرجوا عنهما بعد فترة قصيرة، فإن مصير الأستاذ “آلان” يكون أشد رعبًا وهولًا، والتهمة “عدم تربية طلابه على حب القائد” مما يكلفه سنين طويلة من عمره يقضيها في المعتقل، وابنته “مريم” صديقة “سالار” في الصف، تعيش في يتم وحزن، وحين بلغت عمر الصبا، و”سالار” واقعًا في هواها، لم يستطع الأخير أن يلتقي بها في أي مكان على أرض هذه البلاد، إلا في أرجاء المقبرة، على أجساد الموتى، وهناك راحت تنشأ قصة حب كتب لها أن تموت وهي لم تكد تولد بعد، حين يعتقل “سلار” العائد قريبًا من بيروت، بعد أن أكمل تعليمه في اللغة الفرنسية. فقط لمجرد الشك في احتمال أن يكون هو صاحب الكتاب الذي يحمل عنوان “الأب والابن” ليقضي بدوره سنوات شبابه في المعتقل، وحين يخرج منه، ويعود إلى البيت، يباغت بموت أمه، وقد صار والده عجوزًا، ووحيدًا، وحتى وإن كان أستاذه “آلان” قد خرج من السجن، فيخرج منه وقد استحال إلى هيكل عظمي، غير أن الصدمة الكبرى بالنسبة إلى “سالار” غياب “مريم” عن البيت، وزواجها. على هذا النحو تنتهي مصائر الناس، وقصص الحب، والأحلام في بلد تحكمه التماثيل الحجرية، كحال النحات “آرام” الذي استهلك عمره في نحت التماثيل، وما من خيار أمامه، طالما أن عناصر الأمن، يواظبون على التردد إلى مرسمه، وحال صاحب المكتبة لا يختلف، فالمكتبة التي كانت المكان الأعز لدى “سالار” تغدو فضاء يعج بعناصر الأمن، ونتيجة للقهر والرعب، يغدو صاحب المكتبة عنصر أمن، ويأخذ على عاتقه التحقيق مع “سالار” عما إن كان هو مؤلف كتاب “الأب والابن” ومن الطريف والعبثي، أن ثمة تقارير في الأفرع الأمنية عن مشتبه بهم، من أمثال المفكر الفرنسي “جان بول سارتر”، والرسالم الهولندي “رامبرانت” وغيرهم، وتصدر بطاقات بحث عنهم في الحواري والأزقة السورية. وكان من الطبيعي في مثل هذه الأجواء الموبؤة بالوشيات والرعب والخوف، إنتاج كائنات متوحشة، حتى إذا ما آن الأوان، سارعت إلى نهش لحم بعضها، ليكتشف “سالار” أنه تحول بدوره إلى وحش، وقد نبتت لديه ذيول، كما حال الآخرين الذين يحيطون به.ضمن هذه الأجواء الغرائبية، صاغ حليم موسى روايته، كمقاربة فنية لواقع الحياة السورية، ليدخلنا في دهاليز ومتاهات، مدللًا من خلالها على مكامن العطب في الحياة السورية، ليكنس العماء الذي استحكم بالإنسان الكردي والأرمني وغيرهما من المكونات السورية، ممن ولد وترعرع في دولة البعث، مفككًا أسرار ما آلت إليه الأمور في الوقت الراهن. فحين يتم الإفراج عن “سالار” يكون قد تحول إلى وحش، في لحظة كانت فيها سلطة الأجهزة الأمنية، أحوج ما تكون لأمثاله من الوحوش، لغزو الشوارع والمدن، لاسيما وأن ضيق السجون بالمتظاهرين، لم يعد يستوعب أعداد الوحوش فيها، مع من يتم الزج بهم حديثًا لتكتمل عمليه وحشنتهم في المعتقلات، وهي وإن كانت مجرد استعارات، وترميزات، إلا أنها صورت بدقة متناهية حقيقة ما جرى في سورية، الدولة المتوحشة، وكلما ظهرت أداة تحول دون توحش الكائن الإنساني فيها، كالكتب واللعب والحب والفن؛ يتم حرقها وخنقها. حتى أن الأغاني والألحان الموسيقية التي كان يواظب عليها “خليلو” الأعمى، آتت الوحوش المتناسخة عن التمثال الحجري لتستأصلها من حياته، وكان لـ”خليلو” الأعمى، صديق “سالار”، الأثر الأكبر في مقاومة هذه الوحشية، عبر معزوفاته الموسيقية وأغانيه العذبة، إلى حد بدا فيه “خليلو”، وكأنه حارس على ما تبقى من الجمال في الحياة، غير أن تلك الحياة وأناسها، بدوا وكأنهم محكومين بلعنة الطاعون، وما من خلاص منها، طالما وأن التماثيل الحجرية جاثمة على صدورهم، وكأن نبوءة الأم “سوسن” كانت تحاكي نبوءة العراف “ترسياس” في مسرحية “أوديب ملكًا” حول مصير ابنها “سالار” الذي يمضي باحثًا عن مصدر هذا الطاعون، ما أوصله في نهاية المطاف إلى الاغتراب عن نفسه، تواقًا للعود إلى رحم الأم، أو الموت، كما هام “أوديب” في عماء عتمته، حين أدرك سبب الطاعون، واستمرت ماكينة الخياطة، بصوتها الذي يطحن عمر والدة “مريم” تعكس أثرًا كبيرًا في خلق الإيقاع الموجع الذي طغى على أجواء رواية حليم يوسف.